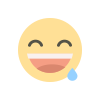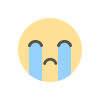موازنات المقاصد الشرعية في مدارك المصلحة وماهية الاحكام

مقدمة
لقد اجمع أهل العلم على أن إصدار الحكم في أمر ماهوا إلا فرع من تصوره، وعلى ذلك نجد أن مجمل الأحكام الصحيحة ماهي إلا خلاصة لحقيقة ذلك الامر، وعلى هذا نجد أن تصور الموازنات في المقاصد على حالين، فهنالك من عرف الحكم الصحيح فأخذ به واهتدى، واخرون من أخطأ المقصد فضلوا عن السبيل، ولذلك فإن من الضروري وضع كل حكم على ميزان مقاصد الشريعة، وفي هذا المقال سنتعرف على تلك الموازنات التي وضعها بن بيه في كتابه، وتلك الموازنات تتلخص في الإجابة على بعض التساؤلات، ماهي مدرك المصلحة بين العقل والنقل؟ وهل تلك الأحكام تعبدية أم معقولة المعنى؟ وما إذا كانت مقاصد الشريعة كلية أو جزئية؟ وسنتعرف على ذلك فيما يلي.
ماهي مدارك المصلحة
في هذه الجزئية يدور النقاش حول إحدى قضايا الموازنات في مقاصد الشريعة، ألا وهي المصلحة بين العقل والنقل، ويقصد بذلك البحث حول المصلحة المبني عليها أحكام الشريعة فيما إذا كانت أحكام عقلية أو أحكام شرعية.
ومن خلال ما سبق يمكن الإجابة على التساؤلات من خلال الأخذ باتجاهين، الأول يرى أن المصلحة تعرف فقط من خلال الشرع، وذلك ما أخذ به الامام الغزالي رحمة الله تغشاه في كتابة المستصفى، حيث أنه تطرق للاستصلاح كونه من الأصول الموهومة والتي ذكر أمثلة بما يرتبط بالاختلاف في درجة المصالح، من حيث مرتبة مقاصدها خاصة في الضروريات، أو الحاجيات، إنتهاء الى مرتبة التحسينات وهي المقاصد الغير ضرورية، وفي هذا الشأن يقول الغزالي رحمه الله "ان من المفترض أولاً فهم المقصود بـ المصلحة، والتعرف على مراتبها والامثلة عليها، وتعرف المصلحة على حد قوله بأنها لغتاً هي كل جلب للمنافع ودرئ للمفاسد والمضار، ويقصد بذلك أن جلب المنافع ودفع المضار ما هو إلا من مقاصد الخلق، وصلاحهم في تحقيق تلك المقاصد وهو معنى مختصر لهذا المفهوم، ولكن المقصود الأساسي بذلك هو أن المصلحة هي فهم قصد الشارع في شرعه، ومن ذلك يتضح أن الإستصلاح لا يمثل أصلاً خامساً بحد ذاته، بل أنه كل ما أستصلح فهو مشروع، وكل ما أستحسن فهو مشروع، وذلك ما يبين مفهوم الإصلاح بشكل عام مما سبق"[1]
ومما سبق نجد أنه لا يختلف كثيرا عما يراه الامام الشاطبي حول مفهوم المصلحة، ونجد في قوله رحمه الله عليه "ان هنالك مصالح عديده تزيد عما يدركه المكلف وذلك ما ورد في عدة مواطن في الشرعية، ولا يمكن للمكلف إستنباط تلك المصالح ولا التعدية بها في محل آخر، وان كانت تلك في فروع الأحكام ولم يرد في الأصل المقصد، فتبقى موقوفه دون سبيل في القياس، كونها فرع من أصل دون علة أو العموم، والاخذ بها كما وضحها الشرع دون أي زيادة أو نقصان.
يمكن فهم العلاقة بين العقل والنفل من خلال إدراك أن العقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح، بل على العكس من ذلك، نجد العقل مؤيد وشاهد للنقل من خلال كونهما من مصدر واحد، فخالق العقل هو منزل النقل.
ومن الصعب التصديق بأن ما أنزله الله يمكن أن يحمل مفسدة للإنسان في الدنيا والأخرة فهذا غير منطقي ولا يستوعبه أصحاب العقول الرشيدة، وفي حال وجدنا تعارض بينهما، يمكن تفسير ذلك من خلال سببين، إما أن العقل لم يستوعب ما نقل، أو أن النقل لم يثبت ما فيه.
ونجد من الأمثلة التي طرحها الامام الشاطبي في ذلك، في التساؤل حول لما لا يحكم الحاكم بين الناس وهو غاضب، فإن أجاب بكونه منهي عن ذلك فهذا يقع تحت التعبد المطلق وهو مصيب في ذلك، وان أجاب بما يؤثر عليه الغضب ويشوش عليه في التحكيم بين الناس، فقد أصاب في ذلك أيضاً كونه أخذ بالمقصد والمعنى، كون القصد يوافق الامر، وهذا جائز.
اما إذا كانت المصلحة تتعلق بالحكم والمفسدة كذلك في كل حكم إختص بها الشارع، فهنا نجد أن الالتزام بما ورد لازم دون تدخل للعقل والتعليل في ذلك، كون المصلحة واردة فيما حكم به الشارع، كون الاطمئنان والتعرف على المصلحة هي حكم الخالق في الخلق، ولا سبيل للتعارض فيما ورد في الشرع وبينما يراه العقل والتفسير، كون الشريعة بشكل أساسي ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد[2].
ويقول الشاطبي رحمة الله عليه أن كل حكم شرعي، فيه مصلحة للعباد سواء في الدنيا أو الآخرة، كون الشريعة الإسلامية إنما وضعت لما فيه من مصلحة للعباد، وقد ورد في حديث النبي ﷺ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كُنْتُ رِدْفَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ علَى حِمارٍ، يُقالُ له: عُفَيْرٌ، قالَ: فقالَ: يا مُعاذُ، تَدْرِي ما حَقُّ اللهِ علَى العِبادِ؟ وما حَقُّ العِبادِ علَى اللهِ؟ قالَ: قُلتُ: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: فإنَّ حَقَّ اللهِ علَى العِبادِ أنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ، ولا يُشْرِكُوا به شيئًا، وحَقَّ العِبادِ علَى اللهِ عزَّ وجلَّ أنْ لا يُعَذِّبَ مَن لا يُشْرِكُ به شيئًا، قالَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ، قالَ: لا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا[3].
ويقصد في تفسير "حق الله" أن ما فهم من الشرع لا إختيار للمكلف فيه، ويجب اتباعه دون تعليل أو إختيار سوا أكان له معنى أو بدون معنى، ومعنى "حق العبد" أن بعضاً مما له مصلحة للعبد في الدنيا فله الإختيار في ذلك، وما كان من مصلحة في الآخرة فهو حق لله، والتعبد هو حق لله على العبد، والعادات هي من حقوق العباد.[4]
فحق الله لا خيرة للمكلف في الإختيار فيه، فيؤخذ كاملاً، سواء كان معقولاً أو غير معقول، كـ العبادات حتى وإن لم يعقل معناها على وجه الخصوص فلا خيرة فيها كونها حق لله، أما في حق العبد، فيعود الإختيار فيه لما فيه يراه العبد من مصالح الدنيا، دون المصالح الأخروية كونها تندرج ضمن حق الله[5].
فالمصالح والمفاسد الدنيوية فتفهم بشكل عام على ما غلب وتؤخذ بالترجيح، فإن غلبت المصلحة فتمثل تلك المصلحة المفهومة عُرفاً، وكذلك الحال في المفسدة إن غلبت، ولهذا فإن أي عمل يشتمل وجهين فينسب إلى الجهة المرجحة سواء في الصلاح أو الفساد، فيؤخذ بما فيه الصلاح، ويتجنب ما فيه مفسدة، وهذا القول ينطبق فقط في الأمور الدنيوية ماهي حق للعباد.
واما إن كانت المصلحة فيما يتعلق به الخطاب الشرعي، فالنظر في المصلحة هي المقدمة على دون ذلك في الحكم العام، والمصلحة في ذلك هي المقصود شرعاً، ويقع الطلب على العبد في تحقيق تلك المصلحة بأفضل طريقة، ولكن إن كانت تلك المقصدة تلحقها مفسدة أو مشقة فليست المقصودة في مشروعية ذلك الفعل، وكما أن درى المفاسد هي الغالبة في الحكم العام، ولذلك فقد ورد النهي في الشرع.
وكذلك الحال في المفسدة في الخطاب الشرعي، فتمثل الغالبة على المصلحة في الحكم الإعتيادي، وتجنبها هو المقصد الشرعي والموجب في ذلك الخطاب، ولهذا جاء النهي فيها، ولكي يتم درء تلك المفسدة بالصورة الصحيحة والاتم، وكما يشهد صاحب العقل السليم، والمقصود بالنهي ليس ما تبعه مصلحة أو أي من ملاذ الدنيا، ولكن النهي المقصود في المحل وما سواه ملغي نهياً.
كما أن كل مصلحة أو مفسدة معتبرة شرعاً فليس فيها أي شبهة في شي من المفاسد وإنما هي خالصة، ولا يتوهم فيها ذلك الإشتباه كون ذلك ليس حقيقة شرعية، كون المصلحة أو المفسدة الغالبة فإنما يراد بها كل ما يجري في العادة الكسبية دون الخروج إلى أي زيادة تقتضي إلتفات الشارع إليها جملةً[6]
وفي الجانب الثاني يرى آخرون في الاكتفاء بالعقل في إقرار المصلحة، فقد قيل في ذلك "إن أغلب مصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالعقل، وذلك معظم الشرائع، فإن أردت التناسب بين المصالح والمفاسد فاعرض ذلك على العقل، إن لم يرد الشرع في ذلك قول، وبعدها تبنى الأحكام على ما توصل له العقل"[7]
وكذلك فقد ربط العز بن عبد السلام بين الشرع والعقل في قوله أن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد فيقع فيها الإعتقاد والتعليل في بيان المصلحة التي وجب تحقيقها وتجنب المفسدة وما يحلق بها، دون الأخذ بالإجماع أو القياس، كون الشرع أوجب ذلك.
ويقول الطوفي في شرحه للأربعين النووية كون المعاملات وما إلى ذلك أن مصلحة الناس تتبع كما تقرر ذلك، وغير ذلك من ادلة الشرع فقد يحتمل فيهما إن يجتمعا أو إن يتفرقا، فإن اجتمعا فيعمل بهما ونعمت، وإن ظهر إختلاف بينهما فالأولى أن يسعى للجمع بينمها، ولكن إن تعذر فتقدم المصلحة على سواها وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله (لا ضرر ولا ضرار)[8].
وحين يستلزم نفي الضرر لتحقيق المصلحة ففي هذه الحالة يتوجب تقديمه، كون المصلحة هي المقصودة من تكليف العباد من إثبات الحكم فيها، فيتوجب تقديم المصلحة على سواها من الوسائل والدلائل الأخرى[9].
اما في المدرسة الأشعرية للغزالي ويتبعها أغلب جمهور المسلمين في قولها عن المصالح، فتقتضي نفي التحسين العقلي، وتعتقد أن يكون النص فقط نقطة لتعريف المصلحة وفهمها، ومن ثم التوسع في ذلك لتشمل كل ما وضحته الشريعة بالنص.
كقولهم المناسب المؤثر ويليه الملائم حتى تقف في أعلى حد من الملائم الواقع في الدرجة الثالثة، ويعرف بـ الجنس في الجنس، ويسميه آخرون "الغريب"، وفي حال لم تظهر أي شهادة معينة فيتوقف ذلك.
وربما قد تتسع تلك الدائرة لتكون شاملة للمصالح المرسلة، في حال لم تتبين أي شهادة معينة ويكتفي بـ شهادة تصرفات الشارع دون أي مخالفة للشرع عامة، ويؤخذ بعض أصحاب المذهب المالكي بهذا القول.
اما بالنسبة للطوفي ومن معه فيعتقد أن المصلحة تمثل الأساس ومن ثم تبدأ بالتوسع حسب المعايير المصاحبة للمصلحة العقلية النافعة والتي قد توقف النص، بدلاً من توقفها أمام ذلك النص وتصير ملغية بالإعتبار حسب قولة على خلاف لجمهور أهل العلم الذين يرون عكس ذلك.
على الرغم من ذلك فإن بعض من جمهور أهل العلم قد أعطوا أقوالاً تشير إلى قليل من رأي الطوفي كقول العز بن عبد السلام الذي سبق نقاشه، حيث يرى أن تعرض بعض القضايا على العقل كما لو أن الشرع لم يرد فيها، كونه بذلك القول يريد التوفيق بين العقل والنقل.
وبالرغم من حسم هذه المسألة لدى أهل السنة من خلال الإجماع على ضبط المناسب والاعتبار بالتحسين العقلي أمر غير مثمر حتى وإن كان يشير إلى حكمة، إلا أن هنالك ضرب من البزوغ في هذه القضية.
ومؤخراً فقد عادت هذه القضية في هيئة حديثة تتكأ على تقديم المصلحة العقلية أو ما يطلق عليه البعض بمفهوم المقصد الجوهري والذي يسعى في إلغاء بعض من أحكام النصوص الشرعية والمقاصد الأخرى.
وقد أوضح بن بيه أن المقاصد الشرعية الرئيسية ثلاثة إما الضروري أو الحاجي أو التحسُّني، وتعود تلك التقسيمات للمقاصد الشرعية إلى إقتضاء النقل في الحكم الغير معزول، وان العقل هو الشاهد المعدل، حيث تمثل تلك التقسيمات السقف لما يتطلبه العقل ويقتضيه النقل، وذلك ضرورة النظر في المسائل التي ترتبط بـ المصالح الدنيوية والعواقب في الدار الآخرة.
وقد أكمل قوله في ضرورة مراعاة المقصد في الإستخلاف الرشيد والعدل العتيد والاستعمار السديد، وذلك ما يمكن ترجمته إلى الحكم الرشيد وتحسين إدارة الموارد والتوزيع العادل وكذلك العدل في الحكم.
حيث لا يتم ذلك إلا من خلال دمج القيم الأخلاقية مع الأسس التي تنشا عليها ذلك البناء الذي أشار إلى مفرداتها سواء على أساس المقاصد الكلية أم الجزئية أو المقاصد العامة والخاصة، وكل ما سبق يمكن أن يشكل نظام متكامل يساهم في رعاية المصالح ودرء المفاسد في ضوء الشريعة الإسلامية.
هل أحكام الشريعة تعبدية أم معقولة المعنى
قبل الإجابة على هذا السؤال، وجب التعرف على مفهوم المعقولية والتعبد، فيقصد بمعقولة المعنى أي قابلة للتعليل، حيث أن مقاصد الشريعة هي الغايات والمصالح التي حددتها الشريعة الإسلامية من اجل تحقيق المصالح للعباد في الدنيا والاخرة.
ويؤخذ في هذا إحدى القولان الشهيران، الأول يشير إلى أن أصل مقاصد العبادات في التعبد، ويجب فيها القبول والتسليم دون تفسير أو تعليل والبحث عن المعاني والغايات الدنيوية فيها، أما القول الآخر فيشير إلى أن مقاصد العادات فيمكن فيها الأخذ بالمعاني والتعليل لفهم مقاصدها ومعانيها، وما غير ذلك فليس مرجح فيه القول.
كما أوضح الإمام الشاطبي ذلك في كون المشاهد لأحوال البعض من أصحاب النفوس الفاسدة والجماعات الخبيثة في هذا الجانب، تراهم يسعون في البحث عن التعليل والتفسير العقلي في البعض من الأحكام التعبدية من أجل التشكيك فيها وتفريق الناس عنها، فتراهم يميلون عن قول الله ورسوله والتساؤل حول العلة العقلية في الخطاب القرآني وهذا محرم.
ونجد أن المقاصد والعلل يحملان معنيان مترادفين، بحيث أن المقاصد هي العلل، ويكون ذلك في حال أن العلة تعني الحكمة، وفي حالة أخرى قد يختلف المعنى في حال كانت العلة وصف ظاهر للحكمة أو تعليل عام، وهذه يطلق عليها العلة القياسية أو الوصف المنضبط، وهو معنى خاص للمقاصد، فلا يمكن أن يقال وجود مقاصد للشارع من شرعة إلا في حال كانت الأحكام معللة.
فعند النظر في مفهوم معقولية المعنى نجد أن ما عرف حكمه وغايته كما عرفه الشيخ عبد الله بن بيه، وفي الجانب الآخر، نجد الأحكام التعبدية وهي تلك التي وردت شرعاً ولم يعلل معناها، فوجب الاتباع دون النظر في الحكم تعليلاً.
والمراد بمفهوم معقولية المعنى أن كل ما عرفت حكمته ووضحت العلة فيه للعقول الرشيدة، وفي المعنى الآخر التعبدي فيشير إلى كل مالم يفهم معناه العقل وإنما يعود لتزكية النفس حسب ما عرفه ابن راشد الحفيد.
ولكن ليس القصد في إنعدام المعنى في الأحكام التعبدية ككل، وإنما يجب الإيمان أن كافة تلك الأحكام تحمل مصلحة للعباد في الدنيا والأخرة، حتى وإن لم تكن المصلحة فيها جلية في الدنيا.
ولا يقصد بذلك أن الحكمة غير واردة في التشريعات التعبدية، فيجب الايقان بأن المصالح واردة في كل حكم تعبدي، دون النظر في التعليل العقلي له، كونه منزل من الشارع الحكيم، الأشد حرص على مصالح العباد.
ويقصد بالتعليل أو المعقولية أن الغاية والمقصد في الأحكام الشرعية المنزلة هي واردة ومعقولة لتحقيق المصالح العامة للعباد في الدنيا والاخرة، ويمكن الإشارة الى أن المقاصد أو العلل والغايات هي معاني مترادفة تمثل الهدف من تلك الأحكام المنزلة، وبيان ما فيها من مصلحة للعباد في الدنيا والاخرة، والعلة يمكن أن تكون معنى مرادف لـ الحكمة[10]، ومن جانب آخر فإن العلة قد تختلف عن الحكمة في حال كانت العلة وصف ظاهري فقط موضوع مكان الحكمة، وكونة عادة ضابط لها ويحققها[11].
وقد ذكر ابن حلولو في الضياء اللامع ما نسبه للإمام الفهري حيث قال “أن الحكم التعبدي غير ملزم فيه أي تعليل بجزئي، بل التعليل بكليّ، مقل العبادات البدنية، فإنما يُعقل من تشريعها هو المعنى الكلي، الذي يشير إلى مرور العباد على شرع الإنقياد، كذلك يتطلب تجديد العهد من خلال عقود الإيمان، وتحقيق الإنقياد والإستسلام بشكل طوعي لما ورد في أحكام الشرع من أوامر أو نواهي، وذلك السر في المداومة على الأوراد والأذكار"
كما أشار الإمام الغزالي – رحمه الله – إلى ما سبق في حديثه عن التعبديات في كتابه "المنقذ من الضلال"، حيث أقر بقوله أن عدد الركعات في الصلوات الخمس، إنما هو معنى غير مدرك للعباد، إشارة منه أيضاً إلى التناسب بين عدد الركعات وأوقات الصلوات، فقال "إن ذلك الأمر لا يرى إلا بعين النبوة" حيث يمثل بقولة الإشارة إلى الحكمة المخفية في ذلك الحكم.
وقد جاء الشاطبي ليفرق بين ما أطلق عليه بالعاديات والعبادات، فإن الظاهر لبادئ الرأي أن القصد في المسببات ملزم في العاديات، لما يظهر في ذلك من صورة للمصلحة، بخلاف العبادات لكونها مبنية على معنى غير معقول، ولذلك فلا يمكن الإلتفات إلى المسببات، كون ما علل به من معاني إنما تعود إلى جنس المصلحة فيها أو المفسدة، والتي هي ظاهرة في العاديات، وليست ظاهرة في التعبديات.
وإن الإلتفات أو القصد إلى المسببات أمر معتبر في العاديات كما في الإجتهاد، حيث أن المجتهد يتسع مجال الإجتهاد لدية من خلال العمل على الأخذ بالعلل والقصد إليها، ولولا هذا الامر لما أستقام إقرار الحكم إلا بنص أو إجماع، ولا يقام فيه القياس، ولذلك فيجب النظر في المعاني المشروع فيها الأحكام والمسببة لتلك الأحكام.
أما في العبادات، فإن الغالب يفتقد إلى بيان المعنى الخاص بها، والعودة إلى ما يقتضيه النص، فإن ترك الإلتفات أجرى على مقصود الشارع في هذه الأحكام.
وعلى ذلك يمكن وصف التعليل العام على أنه يتمثل في وجود الأحكام والمقاصد، وكذلك الوصف المنضبط الظاهر، أو التعليل القياسي، وهنا يتمثل الأساس في المقاصد، حيث أن الأحكام الشرعية قائمة بحد ذاتها وبالرغم من ذلك فإن أحكام الشريعة معللة ومفهومة بالعقل.
وهنا يمكن التعريف بالتعليل العام بأنه كل حكم من الأحكام الشرعية يمثل مقصد من وراء شرع ذلك الحكم، وهذا المقصد يشير إلى حكمة الله ولطفة بالعباد ورحمته، والعلة أو المقصد العام المفهوم، تشمل الحكم والمصلحة من التشريع والعمل به.
اما في التعليل بالمعنى الخاص، فإن الأصوليين قد ركزوا على وجود العلة بأخذها أساس للقياس، حيث يمثل هذا الجانب محل اتفاق بين الأصوليين والاخذين بالتعليل والقياس في أحكام الشريعة.
وبشكل عام فإن المسلمون وائمة الإسلام قد أخذوا بمسألة التعليل في الأحكام الشرعية في بيان المصالح من تلك الأحكام، حيث أصبحت تلك المسألة من المواضيع الهامة لدى جمهور الإسلام، ويتفق عليه الأغلب من المسلمين، ويرى البعض عدم جواز القول بأن أي حكم شرعي منزل لا يمثل علة أو مصلحة أساسية، حيث ترى هذه الجماعة أن أي حكم لا يخلوا من وجود علة ومقصد أساسي منه، في حالة كانت مدركة بالعقل أو غير مدركة، وهذا الرأي الأغلب[12].
وبالرغم من اجماع الكثير من علماء المسلمين على الرأي السابق، إلا أن البعض يعارض ذلك القول، وقد إختلف العلماء حول قضية الأحكام الشرعية بين المعقولية والتعبد، فالبعض قد أخذ في ذلك الامر من خلال التفريق بين مسألتي العبادات والمعاملات وما فيها من أحكام شريعة، فيرى أن الأولى في هذه المسألة الأخذ بالعبادات قبل الأخذ بالمعاني والتعليل، كون الأحكام الشريعة المنزلة موجبة دون النظر في مقاصدها، ومن ثم الأخذ بالتعليل ومعقولية المعنى.
وقد إختلف العلماء في مسألة الأخذ بالأحكام الشرعية، على قولين، الأول فيما إذا كانت الأحكام الشرعية المنزلة مدركة بالعقل في بيان مقاصدها والمصلحة العامة منها، فإن الأخذ بالمعقولية في هذا القول ضروري سواء في بيان المصلحة والمنفعة أو درء المفاسد، ويطلق على هذا بالأحكام معقولة المعنى.
وهنا قيل وجوب البحث عن المصلحة في جملة تلك الأحكام المنزلة والتعرف على مقاصد الشارع الحكيم من شرعه، كون الأخذ بهذه العلاقة تمثل تحقيق للمصلحة العامة التي أرادها الشارع في جملة أحكامه، ويقول عبد الوهاب خلاف بضرورة الأخذ بالقول السابق حتى وان عرضت عليهم واقعة غير واقعة النص بحيث تبين لهم أن العلة تتحقق فيها، فإن الحكم يؤخذ بواجب النص من اجل تحقيق المصلحة التي أرادها المولى عز وجل[13].
امام في الجانب الآخر والذي يشير الى الأحكام التعبدية، وهي تلك الأحكام التي لم يظهر فيها جلب للمنافع أو درء لمفسدة، ولكن بالرغم من ذلك فيجب العمل بها كما نزلت كون ذلك من الأعمال التعبدية التي أمرنا بها المولة عز وجل.[14]
اما في قول الشافعي حول القياس في العبادات، فقد رأى في الكف عن ذلك القياس إلا في حال كان المعنى ظاهر بحيث لا يحمل أي ريب، ولذلك نجد أنه لم يحمل القياس في التكبير والتسليم والفاتحة والسجود وغيرها من العبادات، وكذلك لم يحتمل القياس في الطهارات كالوضوء والقيم الإسلامية الأخرى، كون العبادات مبنية على الإحتكام للنصوص الشرعية.
والمعني بالإحتكام، هو ما خفي على العباد على وجه اللطف فيه، كما قال الشافعي، حيث أن شروط الصلاة واحكامها واركانها تمثل من أشكال اللطف بالعباد وصلاح لهم في الدنيا والآخرة، دون أن يكون للبشر إطلاع على ذلك اللطف والصلاح، فيجب إتباع ما أنزل دون البحث والتعليل والقياس لتلك الأحكام المنزلة.
ولا نعني بما سبق أن رعاية المصلحة أمر واجب على المولى عز وجل، ولكن من خلال المعرفة والإيقان بأن ما أنزل الله من أحكام وآيات، تحمل مصلحة في صلاح شؤون العباد في الدنيا والآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل تأثير بالأغراض وأي تغيير بالدواعي، بل أن كل حكم منزل إنما هو مشروع لتحقيق مصالح العباد، بحيث أن يكون ذلك مأخوذاً شرعاً كونه من التعبديات وليس بالعقل والتفسير.
وقد اجمع علماء الإسلام بمختلف المذاهب وكذلك الأصوليون بالقول على أن أحكام الشريعة لا تخلو من مصلحة أساسية فيها، كون مجمل أحكام الشريعة إنما نزلت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، سواء كانت مدركة بالعقل أو غير مدركة فيجب الأخذ بها.
فالأحكام هنا قد تكون تعبدية وان أدركت بالعقل والتعليل في مقاصدها فهي أحكام معقولة وكان الأخذ بها واجب أيضاً، وفي حالة تعارضت معقولية تلك الأحكام عما ورد في النص، فيجب الأخذ بالنص، كونه مصدر شرعي منزل من الشارع الحكيم فتسمى هذه الأحكام بالأحكام التعبدية[15].
ويجب علينا كمسلمين الإتباع والسمع والطاعة في كافة الأحكام التعبدية المنزلة من الشارع الحكيم، والتي تمثل صلاح للعباد في الدنيا والأخرة، دون البحث عن تفسيرها ومعانيها، كونها لا تحمل مجال للتعليل العقلي، إلا في حال كان التفسير لا يحمل أي خلاف مع معنى النص المنزل، وفي هذه الحالة يزيد من إيماننا بها وإعتقادنا اليقين بالمصلحة من كل ما أنزل.
هل مقاصد الشريعة كليه أو جزئية؟
بعد التعرف على علم المقاصد واعلامه ودور هذا الموضوع في إيضاح وبيان الأحكام الشرعية وتصحيح رؤية المسلمين لتلك الأحكام واستنباط المصلحة التي تتحقق في اتباع تلك الأحكام الشرعية المنزلة، وكذلك بيان أحكام الشريعة من حيث كونها معقولية المعنى أو تعبدية، وما اجمع عليه علماء المسلمين في هذا الجانب، وهنا نأتي لمتابعة دراسة جانب آخر من هذا العلم الجليل في الإجابة على تساؤل هام فيما إذا كانت مقاصد الشريعة كلية أم جزئية.
حيث ورد في كتاب الموافقات للإمام ابي إسحاق الشاطبي – رحمه الله – منهجية خاصة في دراسة علم المقاصد وبيان جزئياته وكذلك التوازن بين قيمة العلم والسنن الكونية والظروف الإجتماعية، والعلاقة بينها بالأسلوب الذي يحدد الطرق الأمثل في التعامل مع تلك الأمور بصورة تمثل التفاهم والتكامل، وبعيدا عن الخلافات وسوء الفهم الوارد.
حيث أن الامام الشاطبي أورد في كتابه بالقول "ان تعلم الأحكام الكلية أمر قطعي لا تعارض فيه، حتى وان إختلفت جزئياته، وهذه القاعدة تؤخذ في مختلف المسائل الأصولية، حيث أن العمل بالقياس قطعي، وكذلك بالخبر والترجيح عن تعارض الدليل الظني القطعي.
فعند الأخذ بالقياس في أمر معين، فإن العمل به يكون ظنياً، وفي الأخذ بخبر معين فلن تجده قطعياً بل ظنياً، وعلى ذلك تؤخذ بقية المسائل، بحيث ألا يكون ذلك قادحاً في أصل المسائل الكلية.[16]
بعد النظر في القاعدة السابقة للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، نجد أن في فهم تلك القاعدة والتعرف على إبعادها يوفر الجهد والوقت المبذولين في إزالة عدة أشكال من سوء الفهم للعاملين في هذا المجال.
كما أن الجزئيات لم تكون موضوعة إلا لكون المقصد الكلي قائم عليها، فإن الإعراض عن الجزئيات يبطل الكلي نفسه في الواقع، لأن ذلك الجزئي والإعراض عنه تشكيك في الكلي من حيث أن الإعراض عن الجزئيات يكون في مخالفة الكليات أو التوهم في مخالفة لها.
حيث أنه في حال أن خالف مقصد كلي جزئياته مع الأخذ بالإعتبار أن ذلك مأخوذ من الجزئي فإنه يدل على أن المقصد الكلي غير متحقق كونه من الممكن أن يتضمن تلك الجزئيات من كلي غير مأخوذ، حتى وإن أمكن ذلك.
فلابد من الرجوع إلى الجزئيات لفهم الكليات، فلا يعتبر الكلي دون جزئياته بشكل مطلق، فيؤكد هذا الأمر في الحفاظ على مقصد الشارع، كون الكلي عائد إلى ذلك وكذلك الحال في الجزئيات، ولهذا فلابد من الأخذ بهما معاً في الإعتبار كون كل منهما مكملاً للأخر.
كما أنها تسهل على المتابع فيما يدور من حوار ونقاش حول تلك القضايا والمسائل المتعلقة بأزمة التخلف والجمود الفكري، بحيث لا يواجه سوء فهم كبير فيما يتمثل عل سوء الظن، وتحيل دون إمكانية التفاهم والتوافق والتعاون.
فنجد العديد من المهتمين بالقضايا الفكرية مؤمنين على أن العلم هو الركن الأساسي الذي تنطلق منه الامة نحو النهوض ومحاربة التخلف، ولذلك قد تجد علماء الإسلام يؤكدون على أهمية العلم وفضلة في ذلك والحث على التعلم والقراءة والاطلاع، حتى اذا وصلوا الى قول يشير الى نسبية العلم وتنافيه مع ما ثبت في الماضي، أو ما شبه في ذلك، تجد أنهم ضاقوا من ذلك القول باعتبارهم أنه عودة ال الخرافة والظنون والتخمين وقولهم على أن الإشادة بالعلم والاستشهاد بالأدلة القرآنية والاحادية النبوية لا يرنوا ليكزن كلاماً أو دعوى، يكذبها التردد من حيث القبول والتسليم بنتائج العلم.
واخرون يؤمنوا بأن القوانين الطبيعية والسنن الكونية والخلقية ماهي إلا أمر ثابت ومستقر في الوجود، ولا يمكن نفي ذلك والسعي في تغيير الامة نحو أي توجه إلا من بعد فهم تلك السنن التغييرية وفهم الدوافع وقوانينها، بحيث يأتي فريقاً آخر يرى أن فيما سبق تطاولا على الله عز وجل من حيث التنقيص من قدرة المشيئة الإلهية، وان القول السابق يتجه نحو الأخذ بالماديات والقوانين الطبيعية دون الايمان المطلق بالقضايا الدينية الغيبية التي لا يجد لها تفسير منطقي.
كذلك يمكن القول بأن الأخذ بالعلم بشكل كلي إنما يبتدأ بالجزئيات والبحث فيها، فنجد ترابط كبير بين الكليات وجزئياتها، وإلا فإن الأخذ بالكلي دون العودة لجزئياته هو أخذ بأمر جون الإقرار به علميا أو إستيعابه.
كذلك الامر عائداً على الجزئيات، فإن الأخذ بها لا يكون إلا لكلي لقبوله والايمان به، ونفي أي من الجزئيات ما هو إلا إعراض عن الكلي القائم عليها، بحيث أن الإعراض عن الجزئيات، يؤكد على أن الكلي لم يثبت حقاً.
ويقول المولى عز وجل ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾[17]، وقد أشار الى القول السابق، السيوطي في قوله "ان أهل العلم من قد نصوا على أن الشخص العامي لا يحق له الإفتاء بأمر حتى وان تعلم مسائل وعرفها، ولكن يفتي بذلك المتعمق بالعلم والعارف بالمسائل الجزئية ووقائعها وارتباطها بالكليات"[18]
وفي هذا الموضوع يرى بن بيه الى ضرورة الموازنة بين الكليات والجزئية، ففي حال خالف الجزئي قاعدة كلية مثبته بالاستقراء، فإن من الضروري النظر فيهما سوية، كون حكمة المولى عز وجل تنص على الجزئيات مع الحفاظ على القواعد الكلية ولكن من خلال الإحاطة بمقاصد الشريعة، فلا يمكن أن يثبت كلي ويستثنى جزئي أو العكس من ذلك، فالأخذ بكلاهما واجب، فلا تتقدم القواعد الكلية بشكل مطلق ولا جزئي كذلك دون الآخر.
وأحيانا يتقدم الكلي ليبين جزئياته، أو العكس من ذلك فنجد الجزئيات تجتمع لتؤكد على القاعدة الكلية، كما في المصالح المرسلة.
المصادر
[1] الغزالي، المستصفى 1، صـ 4014 - 432
[2] أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات 2، صـ 533
[3] الراوي: معاذ بن جبل | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 30 | أحاديث مشابهة | خلاصة حكم المحدث: صحيح
[4] أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات 2، صـ 539
[5] نفس المرجع السابق 2، صـ 539 – 540
[6] أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات الجزء الأول ، صـ 16
[7] العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الانام 1/28
[8] الراوي: أبو سعيد الخدري | المحدث: النووي | المصدر: الأربعون النووية | الصفحة أو الرقم: 32 | خلاصة حكم المحدث: حسن، وله طرق يقوي بعضها بعضا
[9] نجم الدين الطوفي، التعيين في شرح الأربعين، صـ 277
[10] الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب، 1981م، الجزء الأول - صفحة 349
[11] وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، 1986، دار الفقه الإسلامي، دمشق، 1/651.
[12] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام الجزء 3، دار الكتب العلمية – بيروت، صفحة 250
[13] عبد الوهاب خلاف، التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه الطبعة السادسة،1993م، دار العلم للنشر والتوزيع – الكويت، ص19-20
[14] العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام 1، ص 28
[15] الامام ابراهيم بن موسى محمد اللخمي الغرناطي، ابو اسحاق الشاطبي، الموافقات في اصول الشريعة ، ج1، دار الكتب العلمية، ص199
[16] ابي إسحاق الشاطبي، الموافقات المجلد الثاني، صـ 487
[17] سورة النساء - الآية 59
[18] جلال الدين السيوطي، الحاوي للفتاوي الجزء الأول، دار الكتب العلمية، ص313

 Amr
Amr